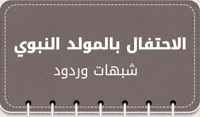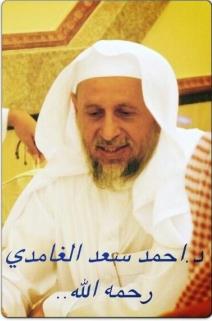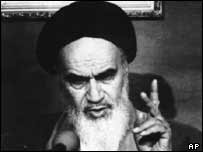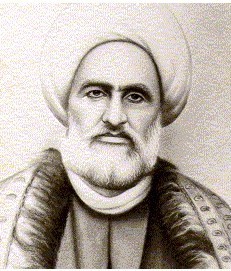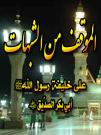نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر
شفيق شقير
الدوافع التاريخية لتطور نظرية ولاية الفقيه
يغلب على الفقه الشيعي الاثنى عشري التقليدي الطابع الفردي، ولم تكن مسألة الحكم والدولة من المسائل الخاضعة للبحث إلا بقدر ارتباطها بالفرد، مما يتطلب ملاحقة عدد من الجزئيات المتناثرة في مسائل فقهية وعقائدية في عصور سياسية متعددة كلها تشير بوضوح تام إلى أن الفقه والفقيه الشيعي (بوظيفته الأصلية) لم يكن واردا أن يقوما بالتنظير أو التعاطي مع السلطة الزمنية إلا بوصفها موقعا مقابلا منفصلا تماما قد يمكن التعامل معه إيجاباً أو سلباً.
الشيعة الإمامية
الشيعة الإمامية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين علياً للإمامة بالاسم والنص المباشر، وإن هذه الإمامة تستمر كذلك في ابنيه الحسن والحسين وتتسلسل بشكل وراثي عمودي في ذرية الحسين، وكل إمام يوصي لمن بعده إلى أن تبلغ الإمام الثاني عشر المهدي الغائب المنتظر.
الإمامة والمهدوية
لم تكن فكرة الإمامة من البداية محددة المعالم، كانت مفتوحة على التاريخ فقهاً واعتقاداً، ومن المفترض أن تمتد من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يوصي بها كل إمام لمن بعده.
فجوهر النظرية الإمامية يعتمد على القول بعدم جواز خلو الأرض من قائم لله بالحجة (الإمام)، ويجب أن يكون معصوما، وتفوق أحيانا تلك التي يثبتها أهل السنة والجماعة للنبي، وهو مشرع ومبلغ عن الله يتصف بالعلم اللدني الإلهي ويوحى إليه من الله بالإلهام، حتى ذهب بعض المناوئين للشيعة إلى اعتبار أن الإمامة هي النبوة وتخالف ما تسمى بعقيدة ختم النبوة.
قال هشام بن الحكم أقدم المنظرين للإمامة وهو يحاور أحدهم: "ولا بد من أن يكون في كل زمان قائم بهذه الصفة (العصمة) إلى أن تقوم الساعة". (الصدوق، علل الشرائع 1/240، الباب 155)
ولكن بعد وفاة الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 260هـ دون إعلانه عن وجود خلف له، أحدث شكاً وحيرة بشأن مصير الإمامة. فافترق الشيعة إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي في "فرق الشيعة"، واحدة منها فقط قالت بوجود خلف للإمام العسكري، وأن اسمه محمد، وقد أخفاه والده خوفاً من السلطة فستر أمره.
ويروي الطوسي في "الغيبة" (ص 141 وما بعدها) قصة ولادة المهدي وما فيها من خوارق، وينقل حديثاً للحسن العسكري يجيب به عمته عن مكان ولده: "هو يا عمة في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له، فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم، وليكن عندك وعندهم مكتوبا، فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده، فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل فرسه (ليقضي الله أمراً كان مفعولاً)". فكانت هذه الغيبة الأولى وتتصل بإخفاء ولادته وسميت الغيبة الصغرى.
استقرار فكرة المهدوية
إن أهمية فكرة المهدي للمذهب الاثني عشري أنها أتمت صورة المذهب عقائدياً، وساعدته على التماسك في وجه التحدي الذي فرضه موت الحسن العسكري دون أن يترك وصياً ظاهراً، فالفترة التي أعقبت موت العسكري اتسمت بحيرة الشيعة وضياعهم، ويصفها محمد بن أبي زينب النعماني في كتابه "الغيبة" (طبعة الأعلمي ص 103): "لأن الجمهور منهم (أي الشيعة) يقول في الخلف (خلف الحسن العسكري) أين هو، ومن يكون هذا، وإلى متى يغيب، وكم يعيش هذا وله الآن نيف وثمانون سنة، فمنهم من يذهب إلى أنه ميت ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده ويستهزئ بالمصدق به، ومنهم من يستبعد المدة ويستطيل الأمد. (الغيبة للنعماني ص 103)
ومن رحم هذه الحيرة خرج القائلون بوجود محمد بن الحسن العسكري واعتمدوا في إثبات وجوده على الأدلة العقلية بالدرجة الأولى، ولكنها كانت موجهة للشيعة فقط، فالمسألة مسألة إنقاذ التشيع وليس نشره.
يقول الشيخ الصدوق في "إكمال الدين" (ص 36): "إن القول بغيبة صاحب الزمان مبني على القول بإمامة آبائه.. وإن هذا الباب شرعي وليس بعقلي محض".
وساعد وجود عدد من الأحاديث السنية التي تحدد عدد الخلفاء والأئمة بأنهم اثنا عشر وعن المهدي وصفته أو عن ولادته وغيبته لدى فرق أخرى كالواقفية الذين قالوا بمهدوية الكاظم ومن شابههم.. فقد ساعد هذا كله على استقرار فكرة المهدوية عند الاثني عشرية، ولكن بالمقابل فإن فكرة غياب الإمام تتناقض مع فلسفة الإمامة التي تقول بعدم جواز خلو الأرض من قائم لله بالحجة ووجوب كونه معصوماً ووجوب التعيين له في كل مكان وزمان. (انظر تطور الفكر السياسي الشيعي لأحمد الكاتب ص 242 وص 131)
وهذا يقودنا إلى الحديث عن النيابة الخاصة عن الإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى.
النيابة الخاصة
استمرت الغيبة الصغرى للإمام المهدي من سنة 260هـ إلى سنة 329هـ وهي المدة التي كان يتصل فيها بالناس عبر نوابه(ويسمون السفراء والأبواب) ولم يوثق الاثنى عشرية إلا أربعة نواب مع أخذ ورد، واشترطوا لإثبات النيابة أن يأتي مدعي النيابة بدليل أو بمعجزة وكرامة تدل على اتصاله بالمهدي (وأورد الطوسي في كتاب الغيبة أخبارهم) وينقل منه الرسائل والتواقيع إلى المؤمنين به ويأخذ إليه الأموال.
وكان علي بن محمد السمري خاتم النواب، وتوفي سنة 329هـ، وكان آخر توقيع نقله عن المهدي فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلي فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله –تعالى ذكره– وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر". ولما كان اليوم السادس قيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: "لله أمر هو بالغه" وقضى (أي مات) فهذا آخر كلام سمع منه (انظر الرواية في الغيبة للطوسي ص 242-243)
وبانقضاء الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى دخل الاثني عشرية في غيبوبة التقية والانتظار.
ففكرة النيابة الخاصة أعطت فرصة للاثني عشرية في مرحلة الغيبة الصغرى كي تعيد النظر في بنائها، واستعملت هذه النيابة في حينها لإثبات وجود المهدي وحماية مذهب الإمامية من الانتكاس والضعف، وأهم ما فيها أنها أرست فكرة جواز النيابة عن المهدي حينئذ، وبهذا أعطت للمذهب الاثني عشري معناه العقائدي، إلا أنها في المقابل فرضت عليه جمودا فقهيا وخمودا سياسيا طال أمده.
ولاية الفقيه وعقيدة التقية والانتظار
بدأت الغيبة الكبرى للإمام المهدي بعد ختم النيابة الخاصة على لسان السمري، وعاد الأمر بالشيعة إلى اللحظة الثقافية السنية التي تقول بخلو الزمان من نبي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يسمى بعقيدة ختم النبوة. إلا أن عقيدة ختم النيابة الخاصة عن المهدي عند الشيعة لم تذهب بهم إلى حيث ذهبت عقيدة ختم النبوة عند السنة، فقد لجأ الشيعة إلى عقيدة التقية والانتظار لظهور المهدي، وذلك لقطع الطريق أمام مدعي النيابة الخاصة وللانسجام مع الأسس التي قامت عليها الإمامة (عدم خلو الأرض من إمام معصوم معين بالنص يتصدى للاجتهاد الديني وللإمامة السياسية).
ومن هنا فقد رفض متكلمو الإمامية الأوائل دعوة المعتزلة والشيعة الزيدية (الذين لم يشترطوا العصمة ولا النص في الإمام) إلى تبني نظرية ولاية الفقيه، التزاماً بنظرية الإمامة والتقية والانتظار، واستناداً إلى فقدان الفقيه للعصمة والتعيين من الله، ولتعارض نظرية ولاية الفقيه مع نظرية الإمامة الإلهية. ودار نقاش حام بين الطرفين حول الموضوع، وقد نقله الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه "إكمال الدين وإتمام النعمة" حيث نقل مقتطفات من كتاب "الإشهاد" لأبي زيد العلوي، وكتاب علي بن أحمد بن بشار "حول الغيبة وولاية الفقيه"، ورد الشيخ عبد الرحمن بن قبة عليهما.
وقد استند ابن قبة في رفضه لنظرية ولاية الفقيه إلى رفضه للاجتهاد وحتمية وجود العالم المفسر للقرآن الكريم من أهل البيت، واستنتج ضرورة اشتراط العصمة في الإمام. (إكمال الدين وإتمام النعمة ص 94-95).
وبهذا أرخت عقيدة التقية والانتظار بظلالها الكثيفة على الذاكرة الشيعية عموماً وعلى ذاكرة المشتغلين بتنضيد الفكر والفقه الإماميين من علماء وفقهاء.
وفي تواصل مع هذه الحقيقة أسست المدونات الشيعية الأولى في إحدى مهماتها وتجلياتها وعياً انتظارياً وفقهاً إخبارياً روائياً يرفض الاجتهاد ويفضي الى تعليق وظائف الدولة الدينية الرئيسية: جباية المال (خمس وزكاة) وإمضاء الحدود والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة صلاة الجمعة وغيرها.. علقت كل ذلك على وجود الإمام المعصوم، أي ظهور المهدي المنتظر، فالغيبة في الرؤية الشيعية كما يقول فؤاد إبراهيم (صاحب كتاب الفقيه والدولة، دار الكنوز ص48-49):
أولا: تعبير احتجاجي على الدولة القائمة يستبطن حجب مشروعياتها.. إلا في زمن الظهور.
ثانيا: أن الغيبة تعني انقطاع إمكانية تحقق الدولة الشرعية (الإمامة) بما يشي أن المحاولة من بعده:
1- ليست ذات جدوى، يقول الشيخ مفيد "ولو كان في المعلوم للحق صلاح بإقامة إمام من بعده لكفى في الحجة وأقنع في إيضاح المحجة". (المسائل الصاغانية للمفيد، طبعة دار المفيد، ص 75).
2- أن الإمامة في وعي الفقيه.. تقع خارج إطار القدرات البشرية.. منظوراً إلى أن الدولة/ السلطة ليست من مهمات غير الإمام الغائب. وفي هذا يذكر الشريف المرتضى في كتاب (الشافي في الإمامة، ج1/ ص112) ما نصه: "ليس علينا إقامة الأمراء إذا كان الإمام مغلوباً، كما لا يجب علينا إقامة الإمام في الأصل.. ليس إقامة الإمام واختياره من فروضنا فيلزم إقامته، ولا نحن المخاطبون بإقامة الحدود فيلزمنا الذم بتضييعها".
3- لو أن ثمة إمكانية لتحقق دولة الحق لحبطت الغاية من الغيبة، لأن الاستتار تعبير عن عدم إمكان تحقق الدولة الشرعية.
ويعقد الشيخان المفيد والطوسي لهذه النقطة مقارنة بين مواقف الأئمة السابقين وموقف الإمام الثاني عشر. يقول المفيد: "إن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمة عليهم السلام التقية وتحريم الخروج بالسيف على الولاة" (المسائل الصاغانية للمفيد - طبعة دار المفيد ص 74).
وكان ذلك يعني إرجاء "إزالة دولة الباطل وإقامة دولة الحق" إلى حين ظهور الإمام المهدي، مما أضفى لوناً قدرياً على الفقه السلطاني الشيعي يحيل إلى تقرير الحتمية التاريخية التي تتوج بالوعد الإلهي بظهور الإمام المهدي..
وانطلاقا من هذه الخلفية القدرية، يستقيل الفقه السلطاني الشيعي أمام الواقع للاضطلاع بمهمة بناء المعرفة الدينية بأمور الغيبة، وصناعة جيل من المنتظرين المتناسلين على امتداد التاريخ حتى تحقق الحتمية التاريخية (ظهور الإمام المهدي).. وهكذا يسقط الفقيه بحث أسس الدولة وإدارة الناس كحاجة اجتماعية ماسة وواقعية، ويتلبس بالتنظير للغائب، فهذا محمد بن إبراهيم النعمان (ت 342هـ – 953م) يؤكد في كتاب "الغيبة" أن الإمامة –حتى في عصر الغيبة– جعل إلهي، وقال: "فمن اختار غير ما اختار الله وخالف أمر الله سبحانه ورد مورد الظالمين والمنافقين الحاليين في ناره".
ويستشف من هذا النص أن لا سبيل إلى العمل على إقامة سلطة أو انتخاب حاكم حتى ظهور الإمام المنتظر، يؤكد ذلك دعوته للشيعة بـ "الصبر والكف والانتظار للفرج وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره"، وعزز ذلك برؤيات تحث على الانتظار في عصر الغيبة.. (انظر الغيبة للنعماني - ص 577).
ونسج عدد من مشاهير فقهاء الشيعة على منوال النعمان مثل الغرار الرازي الضمي (381هـ) في "كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثنى عشر"، وابن بابويه محمد بن علي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381هـ) في "إكمال الدين وإتمام النعمة" و"الاعتقادات"، والشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة (ت 460هـ) في كتاب "الغيبة".
وقد انعكست تلك المعتقدات التي قال بها فقهاء الشيعة الأوائل على تصنيفاتهم الفقهية فقرروا تعطيل بعض الحدود والأحكام، وما يدخل حسب اعتقادهم في ولاية الإمام المعصوم.
ونقف في بحوث الجهاد والقضاء الشرعي وصلاة الجمعة كمعايير اختبار لمشروعية الدولة في الفقه الشيعي.. فقد اشترط فقهاء الشيعة الإمامية وجود "الإمام العادل" أي المعصوم أو نائبه الخاص كشرط لوجوب الجهاد وإقامة الحدود وصحة انعقاد صلاة الجمعة.
ذروة الاجتهاد وبذور ولاية الفقيه
لقد كان الدافع للشيعة في نفي الاجتهاد شبهة استغناء الأمة عن الحاجة إلى المعصوم. ففي هذا السياق منع الشيعة الأوائل الاجتهاد، واكتفوا بجمع الأخبار وتدوينها، فكانت وظيفة الفقيه الرواية فقط بناء على الاعتقاد السائد بكفاية النص الديني في غياب المعصوم، مما يحيل إلى نفي مطلق لنيابة الفقيه عن الإمام المعصوم، وما زال لهذا الخط أنصار ويسمون "بالإخباريين". والحقيقة أنها الصورة الأصلية التي ولد عليها التشيع الاثني عشري.
ودأب علماء الشيعة الأوائل على منع الاجتهاد ورد القياس، فألف النوبختي في القرن الثالث الهجري كتابين في إبطال القياس ونقض اجتهاد الرأي، ولأئمة أهل البيت روايات في ذلك منها عن الإمام جعفر الصادق: "إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعداً". (أصول الكافي للكليني 1/75).
ولما ألف محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي (ت 378هـ) كتابه "تهذيب الشيعة" وأخذ فيه بالقياس والاجتهاد واستنبط الفروع على طريقة فقهاء السنة، أثار حفيظة العلماء فردوا عليه، منهم المفيد في "النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي"، وقال في رسالة "في أجوبة المسائل السروية" (طبعة دار الكتب التجارية ص 56-57): "فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين والقياس ولم يفرد أحد الصنفين عن الآخر".
وقال المرتضى في "الانتصار" رداً على الجنيد: "إنما عول ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطؤه ظاهر". وقال في "الشافي في الإمامة": "إن الاجتهاد والقياس لا يثمران فائدة ولا ينتجان علماً فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما" (1/169).
ونجد أن الطوسي وهو علم من أعلام الخط الأصولي الاجتهادي، بل يعده البعض المؤسس لهذا الخط، نجده في كتابه "العدة في أصول الفقه" في باب الكلام في الاجتهاد قد بالغ في نفي القياس بما يؤدي إلى تعطيل الاجتهاد، رغم أنه لا يرمي إلى ذلك.
ولكن الأمر لم يستقر على ذلك، فاستطالة ظهور الإمام المهدي وتقدم الزمن وإلحاح الحاجة وكثرة النوازل قد دفعت ببعض فقهاء الإمامية للسير قدماً في فتح باب الاجتهاد وخرق أبواب فقهية كانت محكمة الإغلاق، حتى كتلك المتوقفة على وجود الإمام المهدي كالجهاد والجمعة وإقامة الحدود.. وغيرها، وعندها تمايزت الشيعة فقهيا إلى خطين: خط أصولي وخط إخباري.
اجتماع ديني
ونجد أن بعض العلماء الذين منعوا الاجتهاد ونفوا القياس قد أخذوا بهما في كتبهم عمليا كالمفيد والمرتضى والطوسي، وأنكروا على الأخذ بالأخبار والواقفين عليها، حيث نقد المفيد الشيخ الصدوق والإخباريين في كتابه "شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد" وبأنهم "يمرون على وجوههم فيما سمعوه من أحاديث ولا ينظرون في سندها ولا يفرقون بين حقها وباطلها ولا يفهمون ما يدخل عليهم من إثباتها ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منهما".
وقد تمايز مع الطوسي العالم الراوي في الخط الإخباري عن العالم المجتهد في الخط الأصولي، ولكن أعقب الطوسي جمود فقهي حيث هيمنت آراؤه ما يربو على القرن، ولم تتحرر منه الشيعة إلا على يد علماء "الحلة"، حيث تحولت مدرسة "الحلة" إلى منهج في السلوك العقلاني تجاوز الكيان المرجعي الذي فرضه جيل المفيد والمرتضى والطوسي.
وبدأ هذا التحول بالشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي (602-676هـ) الذي استطاع أن يحرر الشيعة من القياس الذي أخذ صورة مقيتة في نظر الشيعة بسبب الروايات الذامة له، وأن يفصل بينه وبين الاجتهاد (انظر معارج الأصول، طبعة مؤسسة آل البيت 1/179)، ودأب الشيعة من بعده على تأكيد مبدأ الاجتهاد وعلى تكرار تأكيد نبذ القياس، رغم أنهم أثبتوا العقل كمصدر من مصادر التشريع وهو أعم من القياس.
واحتل الفقيه بهذا موقعاً مميزا بعد أن أخذ موقعه إلى جانب النص، حيث ذهب محمد بن مكي العاملي (ت 876هـ) المعروف بالشهيد الأول إلى "وجوب الاجتهاد على من لديه القدرة وأوجب على العاجز التقليد" (انظر الذكرى طبعة حجرية ص 129).
وفي العصر القاجاري دافع الشيخ الجناحي (كاشف الغطاء) (ت 1228هـ) عن مبدأ الاجتهاد في مواجهة الإخباريين وجعله من "المناصب الشرعية" وأن المنكر لذلك "جاحد بلسانه معترف بجنانه وقوله مخالف لعمله" (انظر كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، انتشارات مهدوي ص 43).
وجاء من بعده تلميذه المولى محمد النراقي (ت 1249هـ) وزاد على أستاذه في إضفاء طابع ولايتي على الاجتهاد يستمد مشروعيته من الله عز وجل وقال بأن "ولاية الاجتهاد.. حق ثابت من الله ومن حججه للمجتهد"، ولهذا لا بد "من وجوب الرجوع إليهم" أي للفقهاء (انظر مستند الشيعة للنراقي، طبعة مكتبة آية الله المرعشي 2/132، 517، 523).
وكذلك ذهب الشيخ مرتضى الأنصاري (1214-1281هـ) والذي عرف بخاتم المجتهدين في تقرير أصولي إلى "بطلان عبادة تارك طريقة التقليد والاجتهاد" (انظر فرائد الأصول للأنصاري، مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيق التوري 1/275).
وأنزل من بعده تلميذه السيد محمد كاظم اليزدي الرأي الأصولي لأستاذه منزلة الفتوى الملزمة (العروة الوثقى ص2)، ويعد اليزدي أول من أثبت باباً بعنوان "باب التقليد والاجتهاد" حيث وضع هذا الباب في كتابه "العروة الوثقى"، وهو الرسالة العملية الواجب على المقلد امتثال ما جاء فيها، وسار فقهاء الشيعة من بعده على منواله، وتكرست مرجعية الفقهاء ودورهم في النيابة عن المعصوم في الاجتهاد والمرجعية الدينية.
وهكذا تبدلت وظيفة الفقيه من راو إلى مجتهد إلى منصب شرعي إلى ولاية مستمدة من الله، فتحت الباب أمام ولاية الفقيه المطلقة.
السلطة السياسية وولاية الفقيه
إن النيابة الخاصة التي استدعتها غيبة الإمام الصغرى قد أعطت إشارة إلى فكرة النيابة العامة للفقهاء في الغيبة الكبرى، وإن كانت الأولى في عصر الغيبة الصغرى تعينت بإذن الإمام ونصه، فإن الثانية في الغيبة الكبرى وجدت بتأويل نص الإمام والشارع (أي بالاستنباط والاجتهاد).
فمنذ